- الرئيسية
- مقالات
- رادار المدينة
زيارة إلى بيتي المحتل في حيّ سيف الدولة
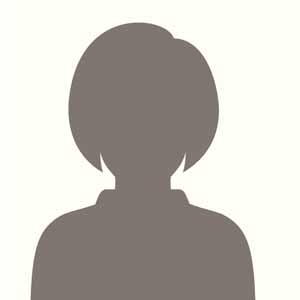 ياسمين محمد
|
2017-02-08
|
الأشرفية
التعفيش
الزبدية
الشبيحة
العدد 87
حلب
حلب المحتلة
سيف الدولة
طريق الباب
ياسمين محمد
|
2017-02-08
|
الأشرفية
التعفيش
الزبدية
الشبيحة
العدد 87
حلب
حلب المحتلة
سيف الدولة
طريق الباب
على مدخل المبنى الذي غادرته منذ بداية كانون الأول 2016 كان للهواء لونٌ آخر، والأبنية مصبوغة بالسواد بتأثير الحرائق التي افتعلت في المكان، فبدا وكأن بركاناً نشطاً زاره وقذف حمم لهبه كيفما اتفق، مخلفاً آثاره على واجهات البنايات.
لم تكن العودة للاطمئنان على بيتي ومحتوياته متاحةً خلال الأيام الأولى التي قضيتها بعد أن قررت الذهاب إلى مناطق النظام مع بداية سقوط العديد من أحياء حلب الشرقية بيد قوات الأسد. كان خروجي قاسياً ومؤلماً، ولم أعتقد أني سأعيش يوماً آخر بهذه القسوة. تجاوزنا حيّ سيف الدولة باتجاه حيّ بستان القصر، في رحلةٍ ليليةٍ عبر الشوارع المليئة بالموت والقناصة، مشياً وأنا أحمل طفلتي الصغيرة بين ذراعيّ وأجرّ خلفي طفلي الأكبر، تاركةً خلفي زوجي المقاتل في صفوف الثورة منذ بدايتها وبيتي الذي يحوي ذاكرة الأيام الجميلة والحزينة والخائفة، مكتفيةً بحقيبة ثيابٍ صغيرةٍ سرعان ما تخليت عنها نتيجة تعب المشي الطويل.
عند الوصول إلى الجانب الآخر من المدينة كان عليّ البحث عن مكانٍ لأنام فيه أنا وأطفالي. أوصلني سائق التكسي إلى أحد الفنادق في منطقة بستان كليب حيث أخذوا هويتي للتفييش و2000 ليرةٍ إيجار غرفةٍ بسريرٍ واحدٍ ودون تدفئة.
بدأت رحلة البحث عن بيتٍ مفروشٍ منذ صباح اليوم التالي لأتفاجأ بالأسعار، فلا يوجد بيتٌ يقل إيجاره عن 50000 ليرة. في النهاية سكنت في حيّ الأشرفية في بيتٍ غير مفروشٍ بإيجار 20000 ليرة.
بدأت اتفاقية الهدنة وخرج أهالي القسم الشرقيّ من المدينة متجهين إلى الريف الغربيّ. وكانت آخر القوافل قد خرجت ومعها زوجي في 22/12/2016، وبدأ الحديث يتعاظم عن قدرتنا على العودة إلى بيوتنا.
لم أكن أستطيع العودة بشكلٍ نهائيّ. خفت من احتمال اعتقالي أو أن يراني أحد الجيران الذين يعرفون زوجي فيشتكوا لرجال الأمن، ولكني أردت أن أستعيد بعض أغراض بيتي.
في 12/1/2017 اتصل بي أحد أقرباء زوجي الذي قرّر زيارة بيته وسألني إن كنت أود الذهاب إلى هناك. تطلب الأمر أن أستجمع قواي وقرّرت الذهاب معه. في الطريق لم توقفنا الحواجز الكثيرة حتى وصلنا إلى مشفى النور بالقرب من حيّ الزبدية، فأوقفنا أحد الحواجز وسألنا إن كان معنا لتران من البنزين، وحين أجابه قريبي بالنفي قال له: «فهمك كفاية»، فأخذ منا 1000 ليرةٍ وسمح لنا بالمرور.
في الطريق إلى سيف الدولة كان الطريق مليئاً بالسيارات، بعضها خاصةٌ والكثير منها سيارات نقلٍ صغيرةٌ (سوزوكي). كان مئات الأشخاص يمشون في الطريق وكأن الحياة لم تتوقف، دهشت من عدد الناس والزحام، ومنعني خوفي من التدقيق في الوجوه.
عند وصولنا إلى المبنى الذي كنت أسكن فيه نزلت من السيارة وداريت وجهي كي لا يراني أحد الجيران. صعدت درج البناية حتى الطابق الثالث. وجدت بيتي بلا أقفالٍ وعليه جنزير. فتحت الباب بيدي ففتح، ولكن أصواتاً صدرت من الداخل استوقفتني. تراجعت خطوةً إلى الوراء، وطرقت الباب.
كان المشهد صاعقاً حين خرجت إحدى النساء لتفتح لي باب البيت. جمدتُ في مكاني. نظرتُ إلى المرأة التي تقطن في بيتي وأشرتُ إلى ما ترتديه وقلت: «هذا ثوب نومي!» فلم ترد. بعد أن استعدت توازني عرّفتها عن نفسي وطلبت منها أن أدخل إلى البيت لآخذ بعض أغراضي إن سمحت لي. كانت تعاملني ببرود صاحبة البيت. قالت إنها من حيّ القاطرجي وإنها نزحت إلى منطقة جبرين وإن الجيش أعطاها هذا البيت لتسكن فيه بعد أن دمر بيتها وأصبح غير صالحٍ للسكن.
طفلتها الصغيرة كانت ترتدي ملابس طفلتي أيضاً. برّرت المرأة أنهم وجدوا الثياب في البيت. أثناء بحثي عن أغراضي التي «عفش» معظمها كما قالت المرأة، ولا أعرف إن كانت قد سرقت أم باعتها الساكنة الجديدة؛ وجدت بعض ما تركوه. كانت المرأة تقول كلما أردت أن آخذ شيئاً: «أنت متأكدة أنو هدول الغراض إلك؟»، وأكتفي بهزّ رأسي.
أخذت بعض الثياب والأشياء الصغيرة لأن السيارة التي جئنا بها لا تتسع لأكثر، وقررت العودة في اليوم التالي لأخذ باقي الأغراض. في طريق العودة أوقفنا الحاجز الذي مررنا به بالقرب من مشفى النور ولكنه لم يأخذ نقوداً، ثم أوقفنا حاجزٌ آخر على بعد مئات الأمتار منه ليسألنا عن مصدر هذه الأشياء وإن كان معنا ما يثبت أنها لنا. لم ينفع عقد البيت في إثبات الملكية ولكن كلمة «فهمك كفاية» كانت صك المرور الجديد القديم، ليأخذ 400 ليرةٍ ويتركنا.
صبيحة اليوم التالي كنا قد جهزنا أنفسنا، أنا وقريب زوجي، للذهاب إلى بيوتنا وحمل ما نستطيع مما بقي لنا هناك. كان الطريق مزدحماً هذه المرّة، وسمعت أن الناس يقفون على دور الإغاثة التي ستوزّع هذا اليوم في الحيّ. رأيت كثيراً من الذين أعرفهم، بعضهم كان من الجيش الحرّ، وبعضهم عمل في مجلس الحيّ. شعرت بأرواح الذين استشهدوا تمرّ في الطرقات التي نسير فيها. رأيت مخفر الحيّ ووجه أبو رحمو الذي كان قائده، ورأيت قاعدة مدفع الهاون التي كانت بالقرب من بيتي، ورأيت أعلام الثورة التي لم يُزلها سكان الحيّ الجدد، والشعارات المكتوبة على الحائط. كل شيءٍ كان على حاله، فقط وجوه الناس تغيّرت والبدلات العسكرية التي تملأ الحيّ. تلالٌ من القمامة أيضاً غيّرت ملامح الطريق، لا أعرف من أين أتت ولكنها كانت كثيرة.
كان التفاوض مع الساكنة الجديدة أصعب هذه المرّة. بدأت حديثها بالقول: «مو بيكفي سمعت أنو اللي كان ساكن هون قائد كتيبة وما حكيت». حاولتُ بكل أنواع اللطف أن آخذ بعض أغراضي، فأنا أيضاً نزحت من بيتي وليس عندي ما أنام عليه. أعطتني سجادتين وبعض الأغطية واستطعت أخذ البراد. لم تكن في المطبخ أي أوانٍ، ولا حتى فنجان قهوةٍ من أشيائي القديمة. غرفة نومي وغرفة الجلوس والتلفاز والغسالة كلها كانت قد سرقت. فرضت عليّ المرأة أن أترك باقي الأشياء وهي تقول: «وأنا شلون بعيش؟ خدي شوي وتركيلي هدول».
سائق السوزوكي، الذي أخذ 15000 ليرة سواء «عبّيتي السيارة أو حطيتي فيها كيلو رز»، أكمل طريقه معنا إلى بيت قريب زوجي في حيّ طريق الباب. هناك كانت الحياة شبه معدومة، لم أر في الشوارع سوى بعض الأشخاص، الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، يتحركون كالأشباح.
أضاع الرجل بيته لكثرة الدمار والتراب في الطرقات. للحظةٍ وضع يده على رأسه ليتذكر المعالم. أمام شارع المؤسسة، التي دلتنا على الطريق، صعد بنا سائق السوزوكي ليجد الرجل بيته قد تحوّل إلى غرفةٍ واحدةٍ وجدارٍ آيلٍ للسقوط. نزل من السوزوكي ليبحث عن معالم البيت الذي تهدم بفعل برميلٍ على الأرجح. فجأةً ضحك وقال: «هاد بيتي»، بعد أن حمل من بين الأنقاض شيئاً راح يمسحه ببنطاله، ثم قال: «هي صورتي». أزال الغبار عن بقعةٍ في الجدار ووضع صورته عليها. سألته فأجاب: «راح كل شي. بلكي بتحمي الحجارة اللي بقيت». غصّ الرجل وامتلأت عيناي بالبكاء.
عند عودتنا أوقفتنا جميع الحواجز، فالسوزوكي التي كنا نستقلها فيها الأشياء التي استطعت أخذها من بيتي. كلما مررنا بأحد الحواجز كانت كلمة «فهمك كفاية» تجبرنا على الدفع، حتى وصلت إلى الأشرفية وكنت قد دفعت للحواجز 7000 ليرة.
عندما بدأت بإنزال أغراضي مرّت بالقرب مني امرأةٌ وقالت: «هيك الصح... الواحد بيجيب غراضو وإيمت ما صحّلو بيرجع». قلت في نفسي: «ليتها تعلم كم استبيحت أغراضي».
على الواتس آب تواصلت معي إحدى الجارات التي كانت تسكن في بنايتي. وحين سألتها إن كانت عادت لتأخذ أغراضها أجابت بالنفي، وأنها ذاهبة إلى الريف الغربيّ. وحين استفسرت قالت: «هدول الخلق مو خلقنا. البلد بناسا، وما ضل شي ينبكى عليه».
الخوف الذي رافقني في اليومين الذين ذهبت فيهما إلى الحيّ كان أكبر بكثيرٍ من الخوف يوم خرجت إلى مناطق النظام، وأكبر من خوفنا من الصواريخ والبراميل المتفجرة. ولكن لعل ما هو أقسى من كل ذلك أن يحتل أحدهم بيتك، يرتدي ثيابك، فتشعر بالغربة في المكان الذي حمل أيامك.








