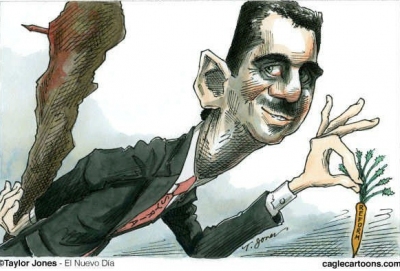- الرئيسية
- مقالات
- رأي
العوامل الداخليّة في قوّة أو استمرارية النظام
عندما اندلعت الثورة السورية في ربيع 2011 كان أكثر المتشائمين يتوقع أنها ستنتهي بالخلاص من النظام في مدّةٍ لا تتجاوز الستة أشهر، وإن امتدت كثيراً فلن تصل إلى العام. ولكنها تجاوزت الخمس سنين ونصف، قتل النظام فيها حوالي نصف مليون، واعتقل مئات الألوف، وهجّر قسراً الملايين، وما زال المبعوث الدوليّ العظيم يسعى إلى إقناعه بضرورة الانتقال السياسيّ الذي يكون لبشار الأسد دورٌ مقيدٌ فيه وليس غائباً بالكامل. فما هي العوامل الداخلية التي كانت خلف ما وصلنا إليه؟
نعم، لم ينطبق حساب السوق على حساب الصندوق كما يقول المثل الشعبيّ، وأغلب الظن أننا لم نحسب جيداً ما في الصندوق.
تلجأ الأنظمة الاستبدادية عادةً إلى بناء روابط خارج أطر المؤسّسات التقليدية، أما في بلدنا فالدولة بكامل مؤسساتها كانت تقوم على قانونَي الاستثناء والتمييز، فكان لبناء الروابط المختلفة دورٌ هامٌّ في سياسة النظام للحفاظ على استمراريته.
كان العامل الأول المتضخم في عهد السلالة الأسدية هو كتلة المخابرات بإدارتها الأربع وتفريعاتها التي تتجاوز الثلاثين، التي ضمت في عدادها عشرات الألوف وتغلغلت في كافة مسامات المجتمع لتفككه وتعيد تركيبه كأفرادٍ بلا هويةٍ لا يثقون ببعضهم. والعامل الثاني هو الجيش الذي كان عقائدياً لحماية النظام، ويخضع بتراتبيته لولاءاتٍ غير وطنية كذلك. أما العامل الثالث، الذي بناه النظام أثناء الثورة، فهو تشكيل ميليشيات الدفاع الوطني (الشبّيحة)، وهم من الفئات الهامشية في المدينة والريف، الذين تمكنت الآلة الإعلامية للنظام من اجتذابهم بحجّة الدفاع عن الوطن، ونتيجة الوضع الاقتصاديّ بعد أن أصبح آلاف الشباب عاطلين عن العمل فكانوا الجمهور الأسهل، إضافةً إلى بعض الميليشيات العرقية (الأرمن) والطائفية (المسيحيين) والمناطقية.
لقد سعى النظام جاهداً إلى إعادة تأسيس تراتبيةٍ لا وطنيةٍ ضمن كلٍّ من الجيش والمخابرات، من خلال خلق روابط أخرى مع أفراد هاتين الجهتين بقصد تعزير ولائهم من خلال الامتيازات التي يغدقها عليهم (سكن، بعثات عسكرية، مكافآت سخية، بعثات دراسية للأبناء، لجان مختلفة في شراء السلاح والتموين)، إضافة إلى ما عُرف بظاهرة التفييش (دفع رشاوى عينية أو مبالغ نقدية للضابط المسؤول مقابل عدم الذهاب إلى القطعة العسكرية، أو مقابل إجازاتٍ متكررة، أثناء الخدمة الإلزامية) دون التعرّض لأيّ مراقبةٍ أو مساءلة، فهيئات الرقابة العسكرية وليدة نفس الآلية.
العامل الأكثر أهمية في تدعيم النظام هو العامل العكسي، أي الذي يكمن في مواقف خصومه ومعارضيه العسكريين والسياسيين، فكلا النوعين قدّم خدماتٍ كبيرةً لصالح استمرار النظام من خلال الأساليب المتبعة في مواجهته.
فعلى الصعيد السياسيّ تشكلت هيئاتٌ منذ العام الأول للثورة وما زالت إلى اليوم خاضعةً للتجديد وفقاً للمصالح والضرورات الإقليمية والدولية أكثر من المصالح السورية، فكانت تعكس خطاباً جامداً يكتفي بالدعوة إلى ضرورة إسقاط النظام، وملحقاً بمواقف الدول الراعية.
وعلى الصعيد العسكريّ كانت الأعداد المتزايدة من التشكيلات المتنافرة، والباحثة عن مناطق نفوذ ومكاسب (غنائم)، يعزّزها وجود الشرعيين الباحثين عن تبريراتٍ لقادتهم من جهة، ودعماً لمواقعهم ولنفوذهم الجديد من جهةٍ أخرى.
يبدو أن العامل الأخير، ولا سيما بالنسبة إلى السوريين الذين خرجوا بثورتهم، هو الأكثر أهمية، وذلك لسبب عدم القراءة المعقولة للوقائع والعوامل المركبة لبنية النظام وتشابكاته وتأثيراتها على الطرف الآخر المعارض. فسياسات النظام، ومفاعيلها في تفتيت المجتمع وزرع الكراهية بين أبنائه، خلقت العقلية الانعزالية التي تقوم على الشك والارتياب بالآخر، مما أسهم بشكلٍ كبيرٍ -بين صفوف السياسيين والعسكريين- في عدم خلق كيانٍ وطنيٍّ فعليّ، بمعنى جامعٍ مناهضٍ للاستبداد ومناصرٍ لقيم الحرية والكرامة التي دفع من أجلها السوريون مئات الألوف من البشر وغُيّب وشُرّد الملايين. بل أسهم في خلق كياناتٍ حزبية، أو مناطقية، شرطها الأساسيّ التنازع في ما بينها والتشكيك في بعضها وصولاً إلى حدّ التخوين، والغوص بعيداً في التفاصيل التي تفرّق أكثر مما تقرّب، وبالتالي الابتعاد عن الهدف الجامع وهو مناهضة نظام الاستبداد. فلعب تنوّع اللافتات الحزبية والرايات العسكرية، بما هي نتاجٌ للعقلية الأمنية التي برع النظام وحلفاؤه في زرعها، والتي تأسّست بعد تفتيت النسيج الاجتماعيّ الأهليّ السوريّ، عاملاً في التفتيت أكثر منه في التقارب، لتعيد تركيب هذا النسيج وفق ثوابت جديدةٍ أهمها تقاسم الكراهية وتبادل الاتهامات.
هذه ليست دعوةٌ إلى العقلية الواحدة ومنع التنوّع والاختلاف، بل إلى التخلص من العقل الانعزاليّ نحو العقل المنفتح والتعامل بإيجابية، واضعين نصب أعيننا الغاية الكبرى وهي الخلاص من الاستبداد، ومصير الوطن الذي تحول إلى قطعٍ جغرافيةٍ للمساومة.


 أحمد عيشة
أحمد عيشة