- الرئيسية
- مقالات
- رادار المدينة
في عيد دمشق.. أضحيات على الأموات وشبه الأموات
صباحاً في أول أيام العيد، وحين أرادت سلمى، أرملة المتطوع في ميليشيا "الدفاع الوطني"، أن تخرج بناتها الصغيرات الثلاث للعب في ساحة بحي الكشكول على أطراف دمشق، وقع حادث غريب عدته المرأة نذير شؤم إضافي في أيامها البائسة؛ سيارة مسرعة تصدم عربة يجرها حصان كانت في طريقها إلى ساحة العيد.
انقلبت العربة وتحطمت، وسحقت أرجل الحصان، فيما لاذ صاحبه بالفرار من الشرطة التي لم تلقِ بالاً للحادثة، وظل الحصان ساعات ينزف جانب الطريق. تقول سلمى "البنات بكيو الصبح على قبر أبوهن، ولما أخذتن ليفرحوا شوي، شافوا هالحيوان المسكين مكسر وينزف دم"، ما أجهض محاولة الأم بالتسرية عن البنات "اليتمات الغريبات الوحيدات بهالأيام اللي ما بترحم".
قبل ثلاث سنوات نزحت سلمى وأسرتها من محافظة إدلب لتقيم في حي الكشكول هرباً "من المشاكل"، حسب توصيفها للغارات الجوية وعمليات القصف المختلفة لقوات النظام والطيران الروسي على المحافظة. لكن وبعد أن أمضى شهوراً عاطلاً عن العمل، اضطر زوجها للتطوع: "عشان يطعمي هالصغار"، حسب ما تروي سلمى حكاية الزوج التي انتهت سريعاً، عندما عثر عليه في الشارع مقتولاً بعدة طعنات على أيدي مجهولين.
ولأنه لم يقتل بمعركة، تنصل قائده من أي التزامات مالية، ولم تتلقَ زوجته إلا الفتات، ولم تعترف به قوات النظام "شهيداً" على الورق، ما حرم عائلته من "حقوق" تحاول سلمى تحصيلها بشتى الطرق، ودون جدوى حتى الآن، غير أن هذا النكران من جانب النظام لها لم ينقص من ولائها الظاهر له، ولم يخفف من اتهاماتها لمن تسميهم "المسلحين" بالمسؤولية عن مأساتها.
في طريقي إلى منطقة جرمانا توقت السيارات في حاجز تفتيش لقوات النظام، انقسم عناصر الحاجز بين من يدقق في هويات ركاب السيارات ومن يتناول طعام الإفطار، وبدا على الجميع حالة من التذمر والملل؛ لم تخفف منها الضيافات التي يحملها بعض الركاب، ومباركاتهم بالعيد، ودعواتهم المتملقة للعناصر بالحفظ والحماية الإلهية.
في الحافلة الصغيرة "السرفيس"، كانت المرأة العجوز في المقعد المجاور لمقعدي أقل تهيباً من باقي الركاب تجاه عناصر الحاجز، كأنهم غير موجودين، وبهدوء أخذت هويتها من العنصر، وعادت للنظر عبر النافذة، قبل أن تسألني عن الساعة، وكأنها تحثني على الكلام لتقطيع الوقت. قالت بأنها ذبحت في هذا العيد أضحيتين، وزعت بعضها على جيرانها، حيث تسكن قرب مشفى المجتهد، وستوزع الباقي على "ناس مستورين ساكنين بجرمانا"، وبأنها اصطحبت حفيدها ليساعدها في حمل الأكياس، "هدا ابن ابني، متل اليتيم"، وأشارت للفتى الذي بدت على وجهه علامات الضجر من "مشوار" لا يحبه.
في الشارع تخففت المرأة من حذرها وأكملت قصة الأضحيتين، واحدة لابنها الشهيد أحمد الذي أوقف على أحد الحواجز ليساق للاحتياط، وينقل، حسب ما عرفت لاحقاً إلى دير الزور، ويقتل هناك، ويعود ممزقاً وضائع الملامح في تابوت. وأما الأضحية الأخرى فهي لابنها المعتقل الذي لا تعرف عنه ومنذ (5) سنوات أي شيء، "الضحية للحي وللميت.. وأنا ما بعرف إن كان عايش أو كان ميت". لم تسمع المرأة، حسب ما قالت، شائعة عن المعتقلين إلا وتتبعتها، ولم يذكر لها محامٍ أو سمسار، أو حتى ضابط سمعت بأنه قد يساعد، إلا وطرقت بابه، ودون أن تصل إلى خبر مؤكد عن ابنها المعتقل خليل، لتظل زوجته شبه أرملة، ويظل أولاده شبه أيتام، ولكن "الأمل يظل بالله كبير"
أصوات المفرقعات النارية التي يشعلها الأطفال حملت مظهراً جديداً لجرمانا في هذا العيد، تقول أم كريم المتحدرة من الطائفة الدرزية التي تشكل أغلبية السكان في هذا الحي، "لو ما الفتيش بين ايدين الولاد ما كنا عرفنا أنه هدا عيد"، فالطائفة التي حرّم رجال الدين فيها الاحتفال هذا العيد حداداً على الضحايا من أبنائها الذين قتلوا في هجمات تنظيم داعش على محافظة السويداء؛ تعيش حزنها الخاص، مثلما تعيش كل عائلة من النازحين في جرمانا أحزانها أيام العيد.


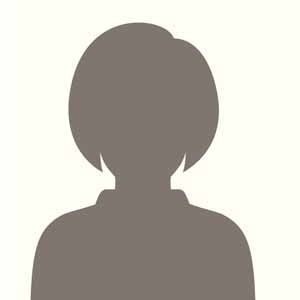 ريّا فارس
ريّا فارس



