- الرئيسية
- مقالات
- رادار المدينة
مصطفى.. الطفل الذي وُلد في «بيت الأرامل».. ومضة من يوميات ديرية
وُلد مصطفى إذن - كان والداه قد اتفقا من قبل على اسمه - وأرسل صرخة الحياة الأولى معلناً ميلاد سوريّ جديد تحدى كل الظروف القاسية، وأصرّ أن يرى نور الحياة.
إنه أذان الفجر. رسالة بأن النهار قد بدأ. ولكنه اليوم فجرٌ مختلف. هاهي رشا جارتنا تضع مولودها الثالث في البيت، رفضت الذهاب إلى المشفى الميداني الذي يحتوي قسم التوليد لأنها مازالت في العدة الشرعية.
استشهد زوجها منذ حوالي ثلاثة أشهر بغارة جوية على الميادين. حملت طفليها ولملمت أغراضها البسيطة: طباخ الكاز الأصفر، ورثته عن حماتها التي توفيت في غرفة بمدرسة للنازحين -ذات غرفة رشا التي كانت تتقاسمها مع زوجها وطفليها وحماتها وشقيق زوجها الشاب- وبعض الأواني البلاستيكية، سكيناً حادة حرصت على إحضارها من بيتها الذي هربت منه تحت وقع اشتباكات عنيفة منتصف 2012، وبقايا أكياس الرز والعدس وعلب الفول التي كان يتم توزيعها على العوائل النازحة.
الخالة صبحية والدة رشا أم شهيد وأرملة شهيد ولكنها أقوى مما تتوقعون، كانت من دعائم الصمود المُشار لها بالبنان في الأحياء المحررة، آوت وأطعمت ومرّضت الكثير من الشبان قبل استشهاد ولدها المقاتل وبعد. ولدها شاب أعرفه منذ كنا أطفالاً، أو ربما يافعين، وأتذكر كيف غيّرت الثورة الكثير من طباعه، فبعد أن كان الفتى المدلل الذي لا يعرف المسؤولية حتى بعد الزواج والأبوة لطفلين، ظل معتمداً على أهله بالكثير من تفاصيل حياته، ثم اختلف بعد الثورة لدرجة أنك لا يمكن أن تراه إلا متفاعلاً فيها ومعها، حتى تخاله يحمل سوريا كلها على كتفيه، متظاهراً في الشارع، ثم مسلحاً ضمن كتائب الجيش الحر، وبعد هذا وذاك شهيداً.
الأب الذي آثر الالتحاق بالعمل الثوري، أو الإنساني، على حسب اختلاف توصيفاتنا ودوائر تصنيفاتنا، بما يسمح له عمره المتجاوز للستين، فكان ضمن الهيئة الشرعية، واستشهد بالقصف على تكية الراوي في رمضان 2012، لتصير الخالة صبحية أماً وجدّة بوجه قوي تُظهره للجميع، ووجهٍ مُنهك تُحاول إخفاءه إلا ببعض اللحظات، عندما كانت تسرّ لأمي بأن الحِمل ثقُل عليها وتجتهد بمساعدة زوجة ابنها بتربية طفليها. ثم تعود إليها رشا مع طفلين وثالث في أحشائها، ليصير البيت «منتجعاً للأرامل» كما كانت تسميه.
قد يبدو التعبير قاسياً ولكنها كانت تُردّده على مسامعنا وهي تضحك، لترسل لنا رسالة بأنها تمزح، ولعل تلك الضحكة كانت وسيلتها لتفريغ الضغط الذي تعانيه وهي تحمل كل هذا الكمّ من الأعباء.
هاهي الخالة صبحية تخونها قوتها اليوم، وتخنقها دموعها، وهي تستقبل مصطفى بين يديها، وتُسمعنا جميعاً كلمات تختصر الحكاية (أبچي على اليتيم اللي انحرم شوفة أبوه)، سلبت منا هذه الكلمات حتى الفرحة المزعومة بقدوم مصطفى.
وبعودتنا -نحن الموجودون- إلى الواقع تنبّهنا إلى أن الأسرة اليوم بلا رجال، فلا أب ولا جدّ ولا خال لمصطفى، ولا حتى أعمام، كانوا بعيدين عن «الشيخ ياسين/ حينا» حيث رشا ومولودها.
عدتُ بسرعة إلى بيتنا في الجهة المقابلة -(أمي أين غزوان؟ نحتاجه على عجل كي يؤذن بأذن المولود) أمي، التي تلبس عباءتها على عجل لتذهب معي، تردّ (نسيتِ أنو غزوان سافر إلى المياذين من يومين!). والآن نحن في مأزق. من يؤذن بأذن المولود؟
شقيقة رشا التي استقبلت مصطفى بين يديها كانت تُحاول أن تكتم دموعها عنها، حقيقة الأمر أن جميع الموجودين كانوا يحاولون تجنّب النظر إلى رشا لكي لا ترى دموعهم. بينما حاولت أنا كبح دموعي، اقتربت منها أُمازحها، فاستجابت لي وضحكت. ربما لأنها تعرف بأننا نتسول منها ضحكة، حتى وإن كنا نعلم -كما تعلم رشا- بأنها مزيفة، وما هي إلا دمعة حارة لبست زيّاً تنكرياً. أنا على يقين بأنكم كنتم ستشعرون بذات شعوري لو رأيتم رشا في تلك اللحظة.
سألتنا السؤال الذي حاولنا أن نُبعدها عن نقاشاتنا المحمومة فيه (هل أذّن أحد بأذن مصطفى؟) همست شقيقتها بأذني بعد أن ابتعدنا عن رشا (شكون يعني. نشحذ أحد من الشارع؟) أفهم أنها كانت بأقصى درجة من الإحباط جعلتها تطرح عليّ مثل هذا السؤال.
وبلحظة لا واعية وجدتُني أحمل المولود بين يديّ، وأرفع الأذان بأذنه اليمنى، وأُقيم الصلاة في اليسرى، بصوت مخنوق مخلوط بمشاعر مهزوزة، غائمة غير واضحة، ربما كانت يائسة أو متفائلة، حزينة مكسورة أو قوية العزم والهمة. لا أعرف حقيقةً ولا أستطيع التوصيف. ولكن… لا يُهمّ، المُهم أن مصطفى سمع ما كان يجب أن يسمعه.
اليوم مصطفى مع والدته وشقيقيه في الشمال، أُتابع صوره التي ترسلها لي أمه باستمرار، تُذكرني بلحظة فعلت بها ما لم أتوقعه قبل ذلك، كسرت بعض القيود ليربح مصطفى، ونربح معه جميعاً روحاً جديدة تُمدّ قلوبنا المتعبة بنسغ الحياة.


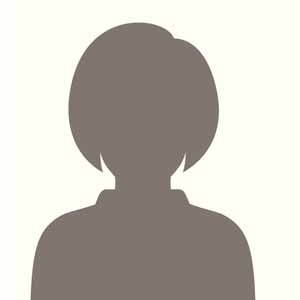 سلام الغدير
سلام الغدير



