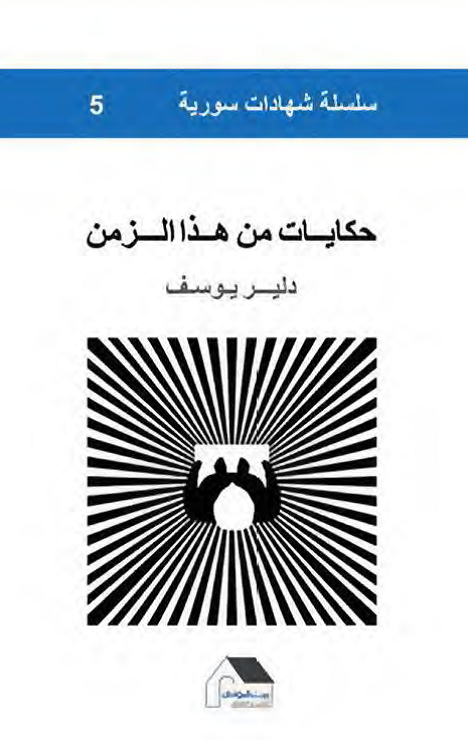جمع دلير يوسف مجموعةً من المقالات التي كتبها خلال سنوات الثورة ونشرت في منابر متعدّدةٍ، كالسفير والحياة وسوريتنا وموقع ألف، في هذا الكتاب الذي أصدره بيت المواطن للنشر والتوزيع، ضمن سلسلة شهادات سورية (5)، عام 2014، بعنوان «حكايات من هذا الزمن».
تتناول المقالات وجوهاً متعدّدةً للثوّارٍ، ولأماكن ساخنةٍ، وانطباعاتٍ ذاتيةً ومشاهداتٍ موضوعية. يرصدها شابٌّ نصف كورديٍّ ونصف عربيّ، بل نصف سوريٍّ ونصف سنّيٍّ أيضاً، تنقّل عبر معظم أراضي سورية خلال الثورة، وخرج منها إلى المهجر وفي جعبته الكثير من القصص.
فها نحن نقطع معه ليلاً طريق التهريب الوعرة من قريةٍ لبنانيةٍ باتجاه الأراضي السورية، بصحبة مجموعةٍ من الشبّان الذين اعتادوا نقل بعض الصحافيين أو الناشطين، وكمياتٍ من الأدوية والتجهيزات الطبية، وأسلحةً وذخائر لمجموعاتٍ من الجيش الحرّ.
وسط عبارات «هالدعسة خطرة»؛ «لا تشغّل ولا ضوّ ولا حتى سيجارة»؛ «دير بالك من الكشافات»... يمرّ الدخول الخطر إلى البلاد. أما الخروج منها فكان أصعب، بعد أن حاصر النظام مدينة العتيبة وبدأ بقصفها، ثم سيطر على الطريق الواصل بين الغوطة وحمص، كما على عقدةٍ طرقيةٍ كان الثوّار يستعملونها، تربط طرق الأردن وتركيا ولبنان والعراق وتصل إلى دمشق. وبعد شهرٍ من الانتظار قرّر أبو مصعب، قائد المجموعة العسكرية التي ستمضي إلى ريف حمص، السير «على بركة الله». تكوّنت القافلة من دراجةٍ ناريةٍ يقودها مستكشف الطريق، وسيارة بيك آب فيها شخصان يعرفان البادية السورية، وسيّارتَي جيب فيهما بعض قادة الكتائب، وشاحنةٍ كبيرةٍ فيها ما يقرب من خمسين مقاتلاً، وشاحنةٍ مليئةٍ بالأدوية التي ستصل إلى حمص القديمة المحاصرة آنذاك، جلس فيها كاتبنا بين علب الدواء.
الطريق الذي يستغرق ساعةً ونصف الساعة، في العادة، استهلك تسع ساعاتٍ ليليةٍ طويلةٍ من أعصاب السائرين فيه، على بعد كيلومتراتٍ عن قطعٍ لجيش النظام، وسط بردٍ قارسٍ ورمالٍ متطايرةٍ تلسع الوجوه. وكالعادة، يُمنع استعمال أيّ وسيلة اتصال، كما يُمنع التدخين أو تشغيل أيّ ضوءٍ، لأن دبابات الأسد ستقصفه على الفور، وخاصةً إذا كان متحرّكاً... ليلة أمس استشهد ثلاثون رجلاً عند محاولتهم اجتياز طريقٍ قريبٍ من هنا!
«حمص العديّة بتلالها وأبوابا/ ضحّت بالشهدا، غنّينالها سكابا». سيكون بيتي في باب السباع، يقول المؤلف، ووجهتي بابا عمرو. سيمرّ طريقي نحو السحاب من البيّاضة. أمرّ بالخالدية لأصل إلى الساعة الجديدة، وأعبر الساعة القديمة وأرى الناس في حيّ الأرمن، ثم أصف شارع الملعب ومطاعمه ومشجّعي نادي الكرامة. حمص هي التي ستخلّد ذكراي إن كتبت عنها، وهي التي ستحيي البلاد من جديد.
ولكنه يتساءل: «كيف أصف حماة؟». كيف يكتب المرء عن شهداء زُرعوا في الأرض كأشجارٍ في غابةٍ تُحيي نفسها كلّ مرّة؟ أم كيف يكتب عن مناطق تصبح أوسع من المدن، كاليرموك، المخيّم/ الوطن الذي عشقه أبناؤه حتى وهم محاصرون فيه، يموتون جوعاً أو قصفاً بالبراميل المتفجّرة.
يستذكر الكاتب صديقه رامي، الفلسطينيّ الذي رفض الهجرة إلى أوروبا لئلا ينقص عدد المطالبين بحقّ العودة واحداً، وتطوّع في الهلال الأحمر الفلسطينيّ-فرع سورية، وفي ما استطاع من منظّماتٍ محليةٍ أو دولية، ليحمل بعض الأغطية لعائلةٍ شُرّدت، قبل أن يجد نفسه في قبضة السجّان، متطلعاً إلى حقه في العودة إلى الحياة وإلى رسم حنظلة على جدار غرفته في جرمانا. كما يستذكر أبو محمّد المقدسيّ، الصديق الفلسطينيّ الآخر، طالب الإعلام الذي جرفته الثورة السورية منذ مظاهراتها الأولى بسبب ما رآه من متاجرة النظام السوريّ بعدائه لإسرائيل ليقمع الناس. ولكن «تحرير القدس لا يمرّ من درعا»، كما يردّد الناشطون الفلسطينيون كثيراً، ويوافق أبو محمد الذي أسهم في تأسيس عددٍ من الكيانات الثورية، كاتحاد شبكات أخبار المخيّمات الفلسطينية، وشكّل، مع فاروق الرفاعي (المتحدّث الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في دمشق وريفها) ثنائياً ذاع صيته في مخيّم اليرموك، لم يوفّرا جهداً يقدّمانه للثورة، كما لم يدّخرا نقداً يوجّهانه لها حين تخطئ.


 محمد عثمان
محمد عثمان