لم تكن مروة تعلم، عند خروجها مسرعةً من منزلها في ريف حمص وسط سورية، بأن رحلتها ستطول لسنوات. وأن كتبها ودفاترها، الذين تركتهم على طاولتها دون أن تغلقهم، "قد يكون رماد الحرب غطّاهم. وأن صورة باربي، التي ألصقتها لي المعلمة بعد أن نلتُ الدرجة الكاملة في الإملاء، أصبحت غير واضحة المعالم"، بحسب قولها.
لا يختلف حال مروة (9 سنواتٍ) عن الكثير من الطلاب الذين أجبرهم قصف النظام على مغادرة منازلهم في الرستن ومناطق كثيرةٍ في سورية، حيث اضطرّ الأهالي إلى ترك الحقول والمحالّ التجارية والورش، وبطبيعة الحال المدارس. فقد بات من جاء إلى الحياة مع قيام الثورة، في آذار 2011، في عمرٍ يفرض على أهله أن يلحقوه بدور الحضانة، ومن كان عمره سنةً أصبح جاهزاً للالتحاق بالمرحلة الابتدائية.
تقع الرستن إلى الشمال من حمص، على الطريق الدوليّ الذي يخترق سورية من الشمال إلى الجنوب. وتعدّ من أوائل المدن التي انتفضت في وجه النظام، وصارت ساحةً للمعارك بين قوّاته والقوّات المناوئة، مما دفع بكثيرٍ من السكان إلى النزوح والتوزّع في ريف حماة الجنوبيّ. واستقرّت مروة، مع عائلتها التي فقدت أحد أفرادها نتيجة القصف الذي طال منزلهم قبل النزوح، في تقسيس، إحدى قرى الريف الحمويّ.
وفي هذه القرية، التي لا يتجاوز سكانها بضعة آلاف نسمة، تطوّعت سامية، وهي فتاةٌ من تقسيس لم تكمل تعليمها الجامعيّ بعد، بتحويل إحدى غرف منزل عائلتها إلى غرفةٍ صفّيةٍ تجمع فيها الطلاب القادمين من الرستن وبعض المناطق الأخرى، بعد أن لم يكن في مقدور المدرسة المحلية استيعاب الأعداد الكبيرة التي طرأت على القرية. كما أن الوضع الأمنيّ لم يسمح للأهالي بالمغامرة بإرسال أبنائهم إلى القرى المجاورة، بعد حالات الخطف مقابل الفدية التي انتشرت في هذه المناطق.
ورغم أن العملية التربوية في هذا المنزل ليست في أفضل حالاتها، إلا أن رغبة سامية في أداء مهمتها الإنسانية، ورغبة ذوي الطلاب في متابعة أبنائهم لمسيرتهم، كانتا كافيتين لتحدّي الظروف الصعبة. تشرح سامية الفكرة بالقول: "كان الهدف من المشروع هو عدم انقطاع الطلاب عن التعليم. ولذلك دفعتنا الظروف إلى وضع تلاميذ من أعمارٍ مختلفةٍ في الصفّ ذاته". وعن ظروف الغرفة تقول: "حين بدأنا المشروع في الشتاء عانى التلاميذ من بردٍ شديدٍ، نظراً لعدم توافر وقود المدافئ في القرية. كنا أحياناً نشعل الحطب. وكثيراً ما عانينا من الدخان في الغرفة، حتى كدنا نختنق". في الغرفة الصفية، التي لا يزيد حجمها عن 4x4، كان يتجمّع أكثر من 25 تلميذاً في درجة حرارةٍ لا تتعدّى 4 أو 5 درجاتٍ على أحسن تقديرٍ. الشتاء قاسٍ جداً في وسط سورية. وكان التيار الكهربائيّ ينقطع لأكثر من 12 ساعةً على مدار اليوم. كان التلاميذ يعلمون أن التيار الكهربائيّ يعود في الساعة العاشرة. فكان الجميع ينتظر –متحمّساً- لحظات الدفء التي كان مصدرها الوحيد مدفأةً كهربائية.
تمكّنت سامية من الحصول على مبلغٍ بسيطٍ من أحد ميسوري القرية، لشراء بعض الأقلام والدفاتر لغالبية التلاميذ الذين خرجوا من منازلهم بالملابس التي يرتدونها فقط، دون أن يحملوا معهم أيّ شيءٍ آخر سوى الحلم بالعودة. وكان كلّ ثلاثة تلاميذٍ يشتركون على كتابٍ واحدٍ من المنهاج التعليميّ، الذي هو ذاته المعتمد من وزارة التربية السورية. أما لحلّ مشكلة السبّورة فقد استعانت سامية بصاحب محلّ ملابس في القرية، أخذت اللوحة الإعلانية الخاصة بمحلّه وحوّلتها إلى سبّورة.
تابعنا الجولة مع سامية، التي أصرّت على اصطحابنا إلى بيتٍ مجاورٍ، قابلنا فيه السيدة نور، التي كانت تعدّ وجبةً من الأرز والدجاج في وعاءٍ كبير. لتخبرنا سامية أن نور اعتادت على إعداد وجبةٍ كلّ أسبوعٍ لتقدّمها للتلاميذ. وقالت نور: "طالب العلم حتى الملائكة تفرد له جناحيها. فمن باب أولى أن نهتمّ بضيوفنا من المناطق التي تعرّضت لدمارٍ كبير، وأن نضع كلّ إمكانياتنا في خدمتهم، وخصوصاً الأطفال. وكما قال تشرشل لئن أخسر الحرب أفضل من أن يتوقف التعليم لعامٍ واحد، فكيف الحال بنا ونحن ندخل عامنا الخامس وبعض التلاميذ أجبرتهم الظروف على الابتعاد عن مقاعد الدراسة!!".
اليوم، تجهّز سامية لإجراء الامتحانات النهائية لتلاميذها، الذين بدوا متحمّسين للانتقال إلى صفوفٍ متقدّمةٍ، بحسب ما أوضح عبد الحكيم: "كنت أحلم دائماً أن أصبح مدّرساً لمادّة اللغة الإنكليزية، لأن والدي كان حريصاً منذ صغري على تحفيظي مفرداتٍ إنكليزية. لكنه اليوم ليس بيننا. لقد فارق الحياة قبل عام. وأنا سأستمرّ في تحصيلي الدراسيّ إلى أن أصبح كما كان يرغب والدي". وكذلك التلميذة صفاء، التي عادت بذاكرتها وهي تخبر سامية عن حلمها المستقبليّ: "حلمت أن أصبح مهندسةً لأخطّط وأبني بلدي كما البلدان المتقدمة، إذ أرسل لنا أخي الكبير صوراً من دبي وكانت أبنيتها رائعةً وأبراجها عالية. ولكني غيّرت قراري اليوم. صرت أتمنى أن أصبح طبيبةً نسائية". لم تستطع صفاء متابعة حديثها، ولذلك توجهنا بالسؤال إلى والدها الذي أخبرنا أنها "كانت حاضرةً عند وفاة إحدى النساء التي تعسّرت ولادتها ولم نتمكّن من نقلها إلى أحد المشافي بسبب القصف الشديد على القرية وقتها".
انعكست الحرب على الأطفال وأحلامهم بشكلٍ كبيرٍ. مروة نفسها، التي كانت تحلم بأن تصبح رسّامة لوحات، باتت اليوم تحلم بأن تصبح طبيبةً كي تتمكن من "معالجة من يتعرّض لإصابةٍ وتكون كلّ الطرق مغلقةً لنقله إلى المشفى فيموت من النزف". أما زميلها في الصفّ أنس فقد كان يحلم بأن يصبح طياراً يحمي الوطن، وصار يحلم بأن يصبح مهندساً مدنياً حتى يتمكّن من بناء منزله الذي تهدّم بسقوط برميلٍ عليه بفعل المروحية وقائدها الطيّار.
عملت سامية على نشر فكرة تحويل غرفةٍ من أيّ منزلٍ في التجمعات السكنية إلى غرفةٍ صفّيةٍ، بين زملائها في كلية التربية. وقالت: "تزايدت مخاطر ضياع جيلٍ من أطفالنا، يقدّر تعدادهم بأكثر من مليونٍ ونصف مليون تلميذ، حتى أن اليونيسف وصفتهم بالجيل الضائع، بسبب تردّي ظروفهم النفسية والصحية، ما يعرّضهم لصدماتٍ قد يصعب الشفاء منها مستقبلاً". ولكن هذه الخطوة، المخالفة للـ"قانون السوريّ"، لم يكتب لها النجاح بعد. إذ يتطلب افتتاح أية مؤسّسةٍ تعليميةٍ خاصّةٍ موافقةً من جهةٍ حكوميةٍ، والأهمّ الموافقة الأمنية!
وبمرور الأيام تتفاقم حالة عدم المساواة في الفرص التعليمية. إذ يعاني الطلاب في المناطق الساخنة من التقطّع والتوقف اللذين أصابا العملية التربوية، في حين أن من فرّوا من هذه المناطق، نازحين داخلياً أو لاجئين إلى الخارج، غالباً ما حُرموا من الفرص والموارد الكافية، سواءٌ في داخل البلاد أو خارجها. وعلاوةً على ذلك، غالباً ما يعاني هؤلاء من التمييز ومن المحدودية في إمكانية الوصول إلى المرافق المتاحة. ووسط حالة الحرمان يُجبر الكثير من الأطفال على العمل من أجل توفير الدعم لعائلاتهم التي خسرت ممتلكاتها وأصولها ومصادر دخلها، بل معيلها في الكثير من الأحيان. كما تأثرت جودة التعليم نتيجة الخسارة التي ألمّت بالبنية التحتية التعليمية، مثل الأبنية والنقل والطاقة والتدفئة والموادّ والتجهيزات والمعدّات. إذ خرجت حوالي 7 آلاف مدرسةٍ عن الخدمة في الرقة وحلب ودير الزور وإدلب وريف دمشق، من أصل 22 ألف مدرسةٍ في جميع أنحاء سورية.
وتختم سامية حديثها بالقول: "بما أننا نعيش هذه الأيام ظروفاً لا تختلف عن تلك التي عاشتها اليابان إبان الحرب العالمية الثانية، رأينا أن نستفيد من التجربة اليابانية في التربية والتعليم. وهي التجربة التي أبهرت العالم، وتفوّقت على الدول التي تعدّ عملاقةً من حيث الاقتصاد والصناعة، ولديها أكبر عددٍ من الخبراء في شتى المجالات بما فيها التعليم. وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تخجل من أن تنقل تجربة اليابان حرفاً بحرف".


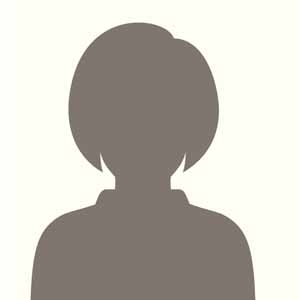 رفيف مسعود
رفيف مسعود



