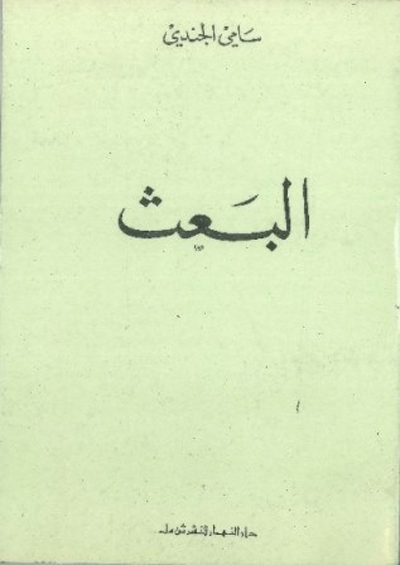عام 1969، عندما صدر هذا الكتاب عن دار النهار ببيروت، افتتحه مؤلفه بالقول: من كان يحسب أن البعث ينتهي إلى كلّ هذا العبث؟ من كان يحسب منا أن تصبح كلمة بعثيّ تهمةً يدفعها بعضنا عنه بسخرٍ مرّ؟ ولم يدُر في خلد الدكتور سامي الجندي على الإطلاق - وهو من الرعيل الأول للحزب وقياداته - أن يصبح البعث مسؤولاً الآن عن هذا القدر المهول من الإجرام والدمار، بعد مرور كل تلك السنوات على وصوله إلى الحكم، وعلى شهادة الجنديّ.

في بداية الكتاب، يستعيد المؤلف أيام البعث الأولى، يوم كان المؤمنون بفكرته مناضلين متفانين، يتنقلون بين القرى بمصروفاتهم الطلابية الشخصية البسيطة، لتبشير الفلاحين ودعوتهم إلى رفض الظلم الواقع عليهم. ودعوة العرب عموماً إلى التوحّد وبناء الدولة القوية ورفض هيمنة الدول الغربية. وقد شارك الجنديّ في هذه النشاطات منذ تشكل أولى خلايا الحزب، قبل الإعلان الرسميّ عن تأسيسه، عندما كان طالباً في جامعة دمشق، عام 1940، مثلما كان معظم أعضاء الحزب في العاصمة. فقد فشل التنظيم في ترسيخ وجوده بين أبناء هذه المدينة، واكتفى بأن يكون جسماً كبيراً برأسٍ صغير. وعبر السنوات تمرّ بالبعث منعطفاتٌ وسياساتٌ مختلفةٌ، وحقبٌ متسارعةٌ من تاريخ سورية. ويسجّل فيها الجندي – الأديب – انطباعاتٍ عميقةً وحاذقةً عن بعض الشخصيات. فزكي الأرسوزي «شاعرٌ يتألق صوراً... وديع المظهر، حتى إذا تكلم بدا ثائراً متوحشاً». أما ميشيل عفلق ففي سلوكه «طيب الفنان وعصبيته وقرفه وسوء ظنه، يصدّق ما يقال له إذا جاء من تلاميذه ويغريه المديح ويخدعه الرياء... إذا أهين حقد». والرئيس شكري القوتلي «من عالمٍ لا ينتسب إلى القرن العشرين، غير قادرٍ على الاضطلاع بكلّ المهمات التي شاء قدر سورية أن تتحمّل أعباءها... لعب به الغرور فقد اعتبر نفسه الأمين على الاستقلال». بينما يبدو حسني الزعيم، الذي انقلب عليه، «مزيجاً من المعتوه ورجل الدولة». وأبرز ما يلفت في أديب الشيشكلي «قسوة وجهه وعجرفة تقاطيعه وصمته... ولكنه غنيّ الحدس يعرف ما يريد، مفهوم الدولة عنده واضحٌ... قويّ الفراسة، قويّ الشخصية... كان يائساً يخفي يأسه حتى عن نفسه... ظلّ وحيداً حتى في أوجه». أما أكرم الحوراني فكان «يبدو عليه صفاء الذهن والعنف، وهما شيئان قلما انسجما معاً... في ضحكه توترٌ يخفي طاقةً كبيرةً وقلقاً عصبياً».. ولكن الشهادة الأبرز في الكتاب هي عن السنوات الأولى من حكم البعث في سورية، إثر انقلاب 8 آذار 1963. وعن هذه السنوات يقول المؤلف، الذي شارك في الحكم كقياديٍّ ووزير، إنها فوضى تحللت من كلّ خلق، مهما حاول المرء الإحاطة بتسلسل أحداثها وفهمه فشل، فالعلاقة الطبيعية بين الأسباب معدومة، وكلّ تعليلٍ خطأ، وكلّ الأحكام صحيحةٌ وكلها غلط! فقد بدأت «اللجنة العسكرية» التي أسّست أيام الوحدة بالسيطرة على الحزب، الذي لم يعد لأيّ مدنيٍّ فيه قيمةٌ جدية، بما فيهم قيادته العليا. إذ صار العسكريون يجتمعون منفردين ويقرّرون الأدوار ثم يهمسونها في آذان القياديين، فيلقون السمع والطاعة من مدنيين نسوا أفكار الحزب ومسيرته و«أووا إلى ظلّ الجزمة». فيما بدأت تظهر على العسكريين أعراضٌ مخيفةٌ، إذ أخذوا يستــــــولون على كــــلّ شيءٍ ويتسابقون إلى المناصب الحسّاسة، يريدون أن يظلوا في الجيش وأن يكونوا وزراء وأعضاء في القيادة الحزبية، يريدون كلّ شيءٍ ولا يعرفون ماذا يريدون. ومن منصبه كوزيـــــرٍ للإعلام يقدّم المؤلف صورةً عن طبيعة حكم تلك المرحلة؛ فبعد أيامٍ ثلاثةٍ على توليه الوزارة جاءه الرفاق بوشاياتهم عن من يريدون تسريحه من الموظفين، في تقارير متضاربةٍ تتهم هذا بالعداء للثورة وذاك بالعمالة لإسرائيل، في وقتٍ كان مقياس نجاح الوزير هو طول قوائم التسريحات! فالحزبيون وأقرباؤهم وبنو عشائرهم متلهّفون لجني ثمرات «النضال» والقربى، وقوافل من هؤلاء أخذت تترك القرى في السهول والجبال إلى دمشق، التي طغت القاف المقلقة على شوارعها ومقاهيها وغرف الانتظار في الوزارات.


 محمد عثمان
محمد عثمان