رأس الأسـد هو رأس النظـام السوريّ، على الأقلّ كرمزٍ لحقبةٍ مرّت بها البلاد، منذ سبعينيات القرن الفائت. وما إن يسقط هذا الرمز حتى تسقط معه الكثير من قيود النظام، إذ إنّ القادم لن يستطيع قمع السوريين. وإن فعل فستكون آلياته عاريةً وضعيفةً إلى حدٍّ كبير، بعكس آليات النظام الحاليّ، التي لم تقتصر فقط على الترهيب بشتّى أنواعه، بل تعدّته إلى خلق بيئةٍ مواليةٍ له، تدافع عنه حتى الرمق الأخير، وهذا أخطر ما في الأمر. فالعلويون، ومنذ استلام الأسد الأب السلطة، أصبحوا فئةً نافذةً، غزت المدن السورية بسرعةٍ، واستلمت المناصب الحسّاسة والفاعلة. فاعتمدوا على النظام في عيشهم، بدفعٍ واضحٍ منه. وأصبح راتبه هو العطاء الذي يجعل من حياتهم جيّدةً، وفي بعض الأحيان فارهة، عكس ما كانت عليه قبل هذه الحقبة. عندما كانوا منبوذين، وضعفاء، وحتّى تسميتهم كعلويين كانت محلّ إدانةٍ لهم. إضافةً إلى الفقر الشديد الذي عانوا منه، فهم يقطنون بيئاتٍ جبليةً قاسية التضاريس والمناخ. حتى جاء الأسد وأخرجهم من انغلاقهم الشديد، لكن حسب ما يقتضي أمر بقائه في السلطة كمستبدّ.
ومن هنا نرى مدى أهمية النظام بالنسبة إلى العلويين. فهم، وعلى مدى قرونٍ، لم يتنفسوا الصعداء ولم يُعترف بهم كطائفة لها الحقّ في الحياة حتى استيلاء الأسد على السلطة. ومن هنا نستطيع أن نفهم حالة التأليه التي وصل إليها بشار الأسد عقب اندلاع الثورة، فقد أحسّوا أنّ هذا الحقبة في خطر، وأن مأساتهم في العودة إلى الجبال والكهوف قادمةٌ لا محالة فيما لو سقط.
هكذا، لم يكن النظام مضطرّاً وقتها إلى أن يلاحق المعارضين العلويين، أو إلى طلب الاحتياط العسكريّ، فقد كانت قاعدته الشعبية مندفعةً بقوّة للدفاع عنه بشكلٍ شرسٍ. وكانت اللجان الشعبية بدايةً، ثم ميليشيا الدفاع الوطنيّ، هي البنى التي عبّأت له ما يحتاج من مقاتلين، يسند إليهم الجرائم التي يندى لها الجبين، بعيداً عن الجيش وعن مسؤولياته المباشرة. ليجعل من صورته، كنظامٍ وكقائدٍ لجيشٍ "عقائديّ"، لامعةً وقادرةً على الاستمرار فيما لو أخمدت الثورة.
ومع تقدّم الثورة وتطوّر آليات دفاعها عن نفسها، اضطرّ النظام إلى زجّ الجيش بكل قواه في معارك أصبحت أكثر ضراوةً، وازدادت تكاليفها البشرية. ومع أفول جميع وعود النظام بأنّ "الأزمة" تشارف على الانتهاء، أخذ العلويون يتحسّسون مستقبلهم، وبدأت الكثير من الأسئلة تنضج في رؤوسهم. كما أنّ الغلاء وفقدان الحاجات الأساسية من السوق، وفقرهم الذي صار يزداد يوماً إثر يوم، جعلهم يعودون إلى شعورهم القديم بأنّهم متروكون لمصيرهم المجهول.
نظـام الأسـد الآن في غـير مـحلّ ثقتهــم، وهـم بالتالي قد فقدوا سندهم. وسقط الأسد عملياً، ولم يبق منه سوى حاجة كلّ القوى الفاعلة إلى وجوده المؤقت. وفقد العلويون معه البوصلة التي تجعل منهم كتلةً تتحرّك باتجاهٍ واحد؛ فمنهم الآن من يشتم الأسد علناً، ومنهم من يتهمه بكافة أنواع العمالة، دون أن يتأتّى عن ذلك أيّة ردود أفعال، سواء من السلطة أم من المجتمع المحيط، الذي يشعر معظمه الآن أن الأسد جزءٌ من لعبةٍ تستهدف فقراء العلويين، في حين كان المساس باسمه أوّل الثورة محض انتحارٍ لأيّ معارضٍ منهم.
فهم، كطائفةٍ، لم يستطيعوا منذ نشأتهم أن يجتمعوا حول مرجعيّةٍ واضحة، بل كانوا يتوزّعون خلف قياداتٍ عشائريةٍ ومناطقية، تجتمع في أحسن الأحيان (إبّان الاحتلال الفرنسي) لتصبح مرجعيّةً هشّةً ينفرط عقدها بسرعة. ومع وصول الأسد إلى السلطة عمل على ضرب هذه القيادات الصغيرة، ليصبح هو المرجع الوحيد للعلويين ومنجاتهم الحصريّة. أما الآن، وقد شارف الأسد الابن على الانهيار، فقد عادوا إلى حالة التشتت والضياع. وهنا صارت الفرصة سانحةً لظهور مرجعيةٍ للعلويين، ليس من الضروريّ أن تكون دينية، ومن الممكن جدّاً أن تكون سياسية. ولم يكن اغتيال قائد الأركان ووزير الدفاع علي حبيب، أو حتى تكبيل وزير الإعلام السابق، محمد سلمان، سوى فصلين بسيطين من محاولات الأسد الدائمة إخفاء نجم أيّ علويٍّ قد يحلّ محلّه.
وهذا كلّه إشارةٌ واضحةٌ إلى أنّ مرحلةً طويلةً من الاستبداد قد انتهت، أو شارفت على الانتهاء. ونستطيع، كقوىً للثورة والمعارضة، أن نخلق بديلاً وطنياً يطمئن الجميع إلى مستقبلهم، قبل أن يخلق غير السوريين هذا البديــل.


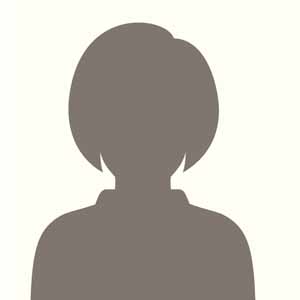 أليمار عباس
أليمار عباس



