- Home
- مقالات
- رادار المدينة
صحفيّة وسط معركة التحرير والأحرار
«يا ولّو وين رايحين وين؟!... يا شباب اطلعوا من بين البيوت... في أطفال ونسوان رح تموت بسببكم... والله حرام عليكم تقتلوا بعضكم!». هكذا صرخت أم أكرم في عناصر تحرير الشام وأحرار الشام الذين جعلوا من مساكن المدنيين متاريس لهم ومن شوارع الحارات ساحات لقتالهم.
شهد ريف حماة الغربي، ومجمل أرياف إدلب، اشتباكات هي الأعنف بين قطبي الساحة في الشمال؛ حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام، الفصيل الذي يشكل مقاتلو «جبهة النصرة» سابقاً سواده الأعظم.
كنت في إدلب عندما بدأت المعارك يوم الاثنين 18 تموز. وخوفاً من تطور الأحداث قررنا العودة إلى منزلنا في ريف حماة الشمالي، مقدّرين أن قريتنا الصغيرة التي ليس فيها أي من الطرفين ستكون آمنة. لم نتوقع أن نحاصر على مدار يومين بين النيران، وأن يصبح منزلنا وسط ساحة المعركة، وأن يمضي أولادي يومهم يبكون من شدة الرعب وهم يشاهدون الذخائر تخترق جدران المنزل، مستلقين على الأرض لا يستطيعون الوقوف خوفاً من الرصاص. وقد تسبّب تعدد مصادر النيران، وعدم معرفة الجهة التي تأتي منها القذائف، في زيادة التوتر. لا يمكنك تخمين الجهة التي ستأتي منها الطلقة لتحتمي بجدار في الجهة المعاكسة، فالرصاص يتطاير من كافة الجهات.
لأني صحفية، وغطيت في عام 2013 بعض المعارك وقصف النظام، لم أكن خائفة كغيري من النسوة اللواتي حاولن أن يحتمين بمنزلنا لأنني وزوجي صحفيان، معتقدات أن المتقاتلين سيحيّدون المنزل! حاولت أن ألتقط صوراً بالموبايل للمقاتلين الذين يتخذون من بيوت المدنيين دروعاً ويختبئون خلف أغصان الأشجار، لكن شباك النافذة حال بيني وبينهم، وطلقات مضاد الطيران التي تخترق عدة جدران (الشيلكا والدوشكا) أفقدتني السيطرة على أعصابي وأضعفت رؤيتي بسبب ارتفاع ضغطي.
استمر هذا الوضع من العاشرة من صباح الخميس 21 تموز حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، عندما بدأ عناصر الهيئة بالانسحاب وتقدم أحرار الشام، لتنتهي الساعات العصيبة التي مرت وتبدأ مرحلة الخوف من تكرار المعارك مع أنباء حشد الطرفين في القرى القريبة.
كان من أصعب الأمور إحضار الماء من البئر خارج المنزل. المسافة لا تتجاوز العشرين متراً، لكن كان عليّ أن أقطعها زحفاً خشية الرصاص الذي لا يفارق أزيزه آذاننا. بسبب انقطاع الكهرباء نستخرج الماء من البئر لأنها باردة قليلاً، ولذلك يجب تجديدها كل ساعة. كان ابني محمود أشجع من باقي الأطفال، رغم علامات الخوف البادية على وجهه، وكان يكرر على مسمعي: «ماما أنا خايف عليكي. بلا ما تجيبي مي، بنشرب المي سخنة ما في مشكلة». أما حلا، ابنة التسع سنوات، ففوجئت بها تلبس كنزة طويلة الكمّين وتضع على رأسها غطاء وتخفي الإكسسوارات التي كانت على صدرها. سألتها باستغراب: «ليش هيك لبستي؟» فقالت: «آنستي بإدلب قالت لنا كل بنت بتمشي بالشارع بدون حجاب بتسجنها جبهة النصرة، وهدول كلهم نصرة» فقلت لها: «صحيح يا بنتي، لكنهم يعتقلون الكبار وليس الصغيرات مثلك».
حدثتنا جميلة (45 سنة) وهي ترتجف. نظرت إلى الأرض وقالت: «عانيت من النزوح عدة مرات خلال الحرب، لكن فرحتنا بالعودة إلى بيتنا بعد سنوات من التنقل لم تكتمل. عندما اجتاحت قوات النظام المنطقة خلال السنوات الماضية لم تقتحم قريتنا لصغرها، ولكن الفصائل المتقاتلة لم توفرها، بل جعلتها ساحة حرب ليومين متتاليين. الخوف الذي شعرنا به أكبر بكثير من خوف وقلق السنين الماضية. شيء لا يصدق أن تكون بين الرصاص وتخرج سالماً. لم أتوقع أن أصل إلى منزل الجيران زاحفة، لم أتخيل أن لديّ القدرة على الزحف لمسافة 500 متر! لا يمكن تصور حالتي، الدموع جفت من كثرة البكاء، والأعصاب تلفت ولم تعد قادرة على حمل الجسد المنهك. صرخات النساء اللواتي أخذن يتنقلن من منزل إلى آخر ضمن الحي ذاته؛ هرباً من الموت، لا يمكن أن تغيب عن البال. أو رؤية منزلك يتحول إلى ساتر يحتمي خلفه عناصر هيئة تحرير الشام، ويكتظ بالمقاتلين الذين يطلقون النيران في كل الاتجاهات، وتشاهد أحرار الشام يستهدفونه بمضاد الطيران وأحجاره تتطاير في الهواء! عندها تشعر أن الحياة توقفت وأنك أصبحت من الماضي، ويبدأ شريط الذكريات يعود لتتساءل عن سبب المعاناة الكبيرة التي وقعت على السوريين!».
تتابع بغصة واضحة: «حاولت وقتها أن أستحضر أشياء جميلة مرّت في حياتي، لأتغلب على الألم الهائل، لكني لم أجد في ذاكرتي أي شيء جميل!».


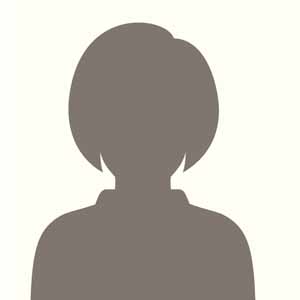 مريم أحمد
مريم أحمد



