- Home
- مقالات
- رادار المدينة
الامتحان في سوريا الأسد وأشياء أخرى
في صباح التاسع من حزيران ذهب الطلاب لتقديم امتحان الشهادة الثانوية مفعمين باليأس، خاصة الشباب، فالهدف الوحيد لمعظمهم هو النجاح لتأخير طلبهم للخدمة الإلزامية، أما المستقبل المجهول فيبدو فيه النجاح والرسوب سيان، فمعظمهم يبحث عن فرصة للهرب من البلد التي تتآكل بالعجز، أما الأهل فيعلمون أن عليهم في مستقبل قريب توديع ابنهم.. فهم الآن في جرمانا الأسد.
يمر الامتحان في سوريا بفجائعيته المعهودة، ربما طعم أيامه المريرة من الأشياء التي احتفظ بها السوريون على مدى عقود حتى اليوم، التجهيز له كالتجهيز للحظة إعدام يتمنى معها ذوو المتهم "إصدار عفو" ما عنه، أو حدوث معجزة سماوية تنقذ فقيدهم. النتيجة مأساوية على الدوام، فالرسوب يعني السقوط النهائي إلى القاع، ويعني في المقام الأول وسماً أبدياً يخرج صاحبه من حظيرة "الصفوة"، أما النجاح فدخول في متاهة الحياة الجامعية المكدسة بالعاطلين عن العمل، والتي تعمل وفق حسابات سلطوية ارتجالية بعيدة كلياً عن الواقع والسوق. عدا عما صبته حرب النظام على رؤوس الشباب.
ماهر في الثامنة عشرة من عمره، يتلقى علاجاً من اكتئاب أصيب به قبل عامين، ما منعه حينها من إكمال دراسته، ويحاول اليوم النجاح في الامتحان بأي ثمن: "ما عندي حل لازم أنجح أو بنطلب ع الجيش، وإذا ما نجحت راحت عليّ"، يبدو نظام التقدم للشهادة الثانوية هزلياً ومريباً، فالطالب يحق له الإعادة في العام التالي في حال نجاحه، أما في حال الرسوب فيحرم من تلك الفرصة ليبقى أمامه خياران، إما الالتحاق بالجيش أو مغادرة البلد بأي طريقة.
يستطيع بعض الأهل تأمين الدروس الخصوصية، يقتطعون من لقمة العيش ويرسلون أبناءهم إلى معاهد معلوم أن بعض أساتذتها يستطيعون تسريب الأسئلة، وهو ما يحصل كل عام في بعض المواد. أما وزارة التربية فلم تعد تأبه حتى لمصير الأطفال المتسربين من المدارس، لتطغى الأمية بينهم وتنتشر عمالة الأطفال، فالأهل لا يستطيعون تحمل إرسال أبنائهم للمدرسة، والبعض بحاجة للدخل الذي قد يحصل عليه الأبناء الصغار، والبعض يعتمد كلياً على ذلك الدخل.
في الصباح ينطلق محمود وهو في الثانية عشرة من العمر حاملاً علبة فيها قداحات، يشتري القداحة بمئة ليرة ويبيعها بمئة وخمسين، يمر بين السيارات عند إشارات المرور؛ يبدو عمله شكلاً من أشكال التسول، لكنه يرفض أن تعطيه نقوداً دون أن تشتري، ويرد عليك بعصبية: "أنا ماني شحاد". يخجل محمود من أميته، لكنه في الوقت نفسه يتحدث كرجل فخور بعمله ومساعدة عائلته النازحة من عين ترما: "ما عندي وقت للدراسة، حاولت بس ما قدرت، لازم ساعد أهلي"، ينهي حديثه ويمضي على عجل ليبيع ما لديه، ويحصل على ما يكفي لشراء طعام الغداء.
تسطع الشمس بلا رحمة فوق الرؤوس فنهرب من حرها إلى الظل، تلمع الفاكهة بأسعار لاهبة ولا أحد من الواقفين يعرف من سيشتريها، يضع أبو حسن السمان بسطة خضار وفاكهة أمام محله، "مين رح يشتري بهيك أسعار، الزبون بيجي بياخد حبتين بطاطا، حبتين بندورة وبصلة، الناس ما معها تاكل". استدان أبو حسن وجمع كل ما لديه من نقود وأرسل ابنه البكر إلى أربيل، يعمل الشاب مهندس الاتصالات هناك مدرساً للغة الإنكليزية، ودخله لا يكفي لكي يرسل لعائلته ما يكفي لسد ديونهم، وأبو حسن يأمل بمعجزة ما في السنوات الثلاث القادمة تساعده على إرسال ابنه الثاني الذي مازال يدرس في كلية العمارة إلى مكان آخر قبل أن يبتلعه اليأس.
يذهب من تبقى من الرجال إلى أعمالهم بعيون يملؤها الفراغ، فقد قتل العجز أرواحهم وتآكلت قلوبهم، يعلمون أن الراتب الذي سيقبضون عليه كثروة في آخر الشهر، لن يكفي إيجار المنزل، أو تكاليف المعيشة، ولن يسد الديون التي تتراكم فوق رؤوس الجميع. عمر في الخمسين من عمره نازح من القدم يعمل شرطياً في وزارة السياحة، عمله يتضمن تسجيل المخالفات التي تتعدى على المناطق الأثرية داخل أسوار مدينة دمشق القديمة، يرفض الرشوة ويعلم أن تقاريره بلا جدوى، فالرشاوى دفعت لمن هم أعلى منه، "بحس حالي عم قاتل طواحين الهوا".
الرجل عاشق للمدينة، ويعلم كم من الحقب التاريخية مرت عليها، يتحدث عنها بشغف، ويعلم أن حربه الصغيرة خاسرة، "الآثار اللي ما دمرها الطيران والمدافع رح يدمرها تجار الحرب محدثي النعمة" يقول عمر، ويؤمن أن المدينة التي صنفت كمدينة أثرية في العام 1979 ستخسر تصنيفها عاجلاً أم آجلاً.
كل شيء هنا على وشك الانهيار، أبنية وبشر تنوء تحت أحمال من الجشع والإهمال، ويزحف ما تبقى من أرواح بلا هدى.. بلا أمل


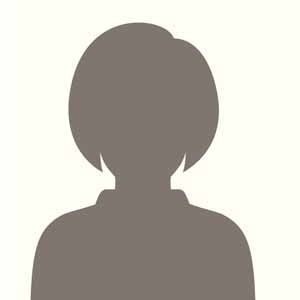 ريّا فارس
ريّا فارس



