- Home
- مقالات
- رادار المدينة
أمي المريضة وأم كلثوم والحرب
امرأة مطلقة في مطلع العشرينات من العمر، أذكرها جيداً وهي تُمعن في إقفال باب غرفتنا عند المغيب، وتعبث بالراديو باحثةً عنها. أدركت صغيرةً أن ما أراه هو سرٌ بيننا. عشقتْ أمي أم كلثوم ورقصت على أغانيها. في ذلك العمر بدأ الاضطراب النفسي يستحكم بها، فمالت للعزلة مكتفيةً بساعة السعادة تلك، التي كانت تبثها إذاعة «إسرائيل» في السادسة كل مساء.
لا تستطيع أمي اليوم التمييز بين الأطراف المقتتلة على الأرض السورية. وتُرعبها كلمة إرهابيين. تتصل بي أحياناً لتطلب مني ألا أخرج من منزلي «عم يقولو في حرب». وتعتقد أحيانا أن الحرب مع «إسرائيل». اختلطت في رأس أمي ثمانينات القرن الماضي وسرايا دفاعها وإخوانها ومجازرها وجارنا الذي عاد في تابوت. اليوم وهي على مشارف الستين من العمر، أمي البسيطة تقطع حارات دمشق القديمة وصولاً إلى العصرونية بحثاً عن صحن «شينكو» بلون أزرق. تعتقد أن أعلام حزب الله الصفراء مجرد زينة لاحتفال ما لا تبالي بمعرفته.
قبل بلوغها الأربعين من العمر أسرّت لي عن عشقها لجارٍ لم يكن بينهما حتى مجرد سلام، فقط أغاني أم كلثوم. كانت تنتظر عودته من عمله، هناك في إحدى الحارات الشعبية كانت تفوح رائحة التنباك من علّية الجار مع أنغام أم كلثوم. كانت أمي تسند رأسها إلى الحائط: (اسمعي اسمعي حطلي لسه فاكر). تزوّج الجار وأنجب وبقيت أمي تنتظر أغنيتها كل مساء. إلى أن اعتُقل في سنة ٢٠١٢، وعاد بعد ثلاث سنوات في تابوت. أرهق الفُصام أمي وأفلتَ الزمن منها، فلا تدري أحياناً في أي عام نحن.
في لحظات صحوٍ أو غياب تتصل بي لتخبرني بأن جارنا مات. (جارنا ما غيرو مات، دريتي؟) (انتي اللي اجيتي لعندي من أسبوع وكنتي لابسة كنزة زرقا؟ أي أنا). كلّ شيء ضبابي في رأس أمي حتى أنا، كل شيء، ذاكرةً وزمناً، حرباً وحباً، كل شيء، إلا أم كلثوم.
لم تستطع أمي يوماً إكمال نشرة أخبار واحدة، لطالما استقت أخبارها من العيون والوجوه والملامح، ومن عدد المارة في الشارع، ومن همسات المقربين هنا وهناك. من شكّها، من ذهانها، من أصوات الأطفال وصراخهم في الحارة. لم تستطع قذيفة سقطت خلف منزلي إيقاظها، لكن صوت بكاء ابنة الجيران أيقظها لتزرع مطبخي جيئة وذهاباً. (أمي تسمعي أم كلتوم؟ إي حطيلي فات الميعاد).
كنت دائماً مصدرها الموثوق للمعلومات، لكني تجنبت خلال السنوات الماضية الخوض معها بأي حديث عما يجري خوفاً من أن يزلّ لسانها على حاجزٍ ما. لكن محاولاتها (المضحكة أحياناً) للتشفير حين تحدثني على الهاتف، تُوحي بأن أمي تعلم ما يجري وإن كانت تتجنب الخوض فيه، ربما خوفاً عليّ.
من المُرهق دوماً إقناع أمي بإعطاء هويتها للحاجز (من تم ساكت) (من وين حضرتَك؟)، سؤالها للعسكري يحمل معه نكهة من يطلب أوراقه الثبوتية أيضاً. فغر الشاب فمه لدى سماعه السؤال، لكن ثقة أمي بالسؤال ربما، أو ملامح اللامبالاة على وجهها، جعلته يجيب وهو يعيد إليها هويتها (من الدير. أي والنعم، كان عنا جيران أوادم من الدير). انطلق سائق التكسي قبل أن تكمل أمي ثرثرتها لتكمل الحديث معي، (تتذكري جيراننا بيت أبو محمد؟ كان عندن بنت من جيلك). لم أعرف أبا محمد ولا أذكر ابنته، كنت في عمر السنتين حين اعتُقل بتهمة انتمائه للإخوان المسلمين، لكني أذكر جنازته بعد سنوات، حين ملأتْ حيّنا رعباً إثر موته تحت التعذيب.
لم أسمع أمي تغني يوماً أو تدندن. تجلس مبتسمة فقط. تضع يدها على خدها قاضمة طرف إصبعها، وحين يغمرها اللحن تتمايل يمنة ويسرة. أراقبها أحياناً بطرف عيني بحثاً عن تلك الصبية التي كانت تعقد شالها العنّابي أسفل خصرها، وتمشي على رؤوس أصابعها.


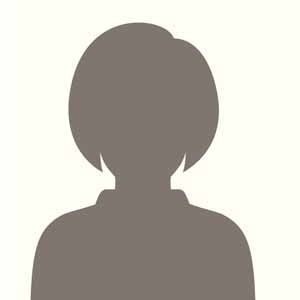 ريّا فارس
ريّا فارس



